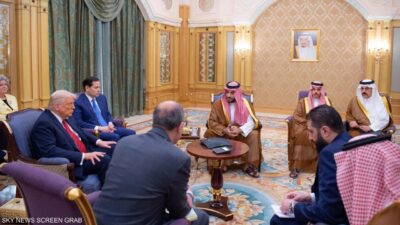رضوان السيد – أساس ميديا
ليس من المجدي ولا المستحبّ المزاح في الأمور الخطيرة، لكن بعد خطابَيْ زعيم حزب الله الأخيريْن ما عاد هناك مجالٌ وسط المأساة لغير ذلك، إن لم نختر الاختناق! رجلٌ أعشى العينين قاعدٌ على جسر الرصافة ببغداد وأمامه قوارير صغيرة ومساحيق، وهو يصرخ: دواء للحبّة، دواء للربّة، دواء للعين! والناس يتزاحمون من حوله ويشترون سوائل مداواة العيون على وجه الخصوص. إنّما أحد المارّة، وعيونه سليمة، لكنّه حِشَريّ ومتذاكٍ، مثل بعض الإعلاميين والسياسيين الذين لا يحبهم نصرالله لأنّهم يتحدّون حلوله بالنقد، توقّف أمامه، وقال: “يا شيخ، أنت توزّع دواء العيون على الآخرين، فلماذا لا تُداوي نفسك؟!”، وما رفع الشيخ رأسه، بل صرخ بأعلى صوته: “ألا ترى أيّها الأهبل أنّ هذا الدواء لبغداد، وقد أُصبتُ في عَينيَّ بأصفهان؟!”. زعيم الحزب يريد إرواء عطش اللبنانيين للبنزين والمازوت بناقلاتٍ للمحروقات من إيران، وإيران الدولة البترولية، التي تمنعها الولايات المتحدة من تصدير البترول، تنشب فيها التظاهرات بسبب ارتفاع أسعار وحداته. ثمّ إذا كانت إيران بهذا السخاء مع الوفرة فلماذا لا تحلُّ أزمة حلفائها في دمشق، بدلاً من تهريب المحروقات إلى سورية من لبنان بإشراف الحزب؟! أم أنّ الشأن هو شأن أعمش الرصافة: الوقود الذي لا يحلُّ مشكلة إيران ودمشق هو القادر وحده على حلّ مشكلة ندرة الوقود (بسبب التهريب) في لبنان! وهل يظنّ القرّاء والمتابعون أنّ هذه هي المرّة الأولى التي يتقدّم فيها السيّد بحلولٍ عجائبية للأزمات المتفاقمة؟ تكونون مخطئين لو اعتقدتم ذلك، فاقتراحاته كثيرة في كلّ حديث، بيد أنّ أهمّ حلوله الاقتراحية وأكثرها عجائبية ما اقترحه على حكومة حسّان دياب، قبل أكثر من عام، لحلّ الأزمة الاقتصادية، وتحرير لبنان من تغوّلات الإمبريالية: لا بدّ من التوجّه شرقاً إلى الصين المشهورة بأعمال الخير، بل كاد يذكر، إضافةً إلى ذلك، التوجّه إلى الاقتصاديين الناجحين جدّاً في سورية وإيران! وعلى سبيل المناسبة، وليس النكتة، هذا هو أو شبيهٌ له ما قاله فيصل المقداد وزير الخارجية السوري لوفد الأحزاب اللبنانية، التي ذهبت إلى دمشق للتهنئة بإعادة انتخاب الأسد: “نستطيع مساعدتكم بالكهرباء وبالسلع الغذائية وبالأدوية”، وبالمحروقات أيضاً!
ماذا فعل السنّة، قيادةً وجمهوراً، إزاء هذا الواقع المقبض؟ عرفنا ردّة فعل الراديكاليّات الصغرى المصنوعة، وهي ليست من طبيعة السنّة واجتماعهم الديني والوطني والاجتماعي. وأمّا القيادة (وقد صارت في الغالب سعد الحريري وحده) فكانت تقابل كلّ تحدٍّ بالتنازل السياسي والوطني
هذه هي النماذج المطروحة من جانب “محور الممانعة” حلولاً للأزمات الساحقة في لبنان. وعلى الرغم من جدواها وآثارها العجائبية، إضافةً إلى وساطة الحزب المستمرّة بين القطبين المتناحرين، فإنّ الحكومة لم تتشكّل بعد، ويبدو أنّها لن تتشكّل في الأمد القريب، والليرة تزداد انهياراً، والناس يجوعون ويترنّحون ويفقدون عقولهم وإنسانيّتهم، ونصر الله يتّهم كلَّ مَن يقول أنّ محور إيران، وهو على رأسه، هو المسؤول عن تعطّل تشكيل الحكومة، بالعبث وقلّة العقل والتآمُر.
ذكرنا زعيم الحزب وذكرنا “إنجازات” نظام الأسد فيما جرى ويجري على لبنان. لكنّنا لم نذكر العضو الثالث الفعّال في مثلّث التخريب ومنع الحلول، وأعني به الجنرال والصهر المأساة والملهاة: جبران باسيل، الذي يبلغ من تفانيه في التطوّع على مدى سنوات المأساة المستمرّة أنّه، وقد خانته قواه بسبب جهاده التحريري المنقطع النظير، أعلن لجوءه أخيراً إلى قدرات السيّد وعدله وإنصافه في خطاب الدواء الذي ينفع في بيروت ولا ينفع في دمشق وأصفهان. إنّه سيظلّ يحاول مساعدته ومساعدة لسعد الحريري ونبيه برّي أيضاً.
ولنلاحظ أوّلاً وآخِراً أنّ هذا الإصرار على التعطيل والتخريب في لبنان والعراق وسورية واليمن لخدمة إيران في تجاذباتها مع الولايات المتحدة، لا يتردّد في مواجهة العالم كلّه، الذي يريد حكومةً في لبنان، وإدخالاً للمساعدات الغذائية إلى سورية، وإيقاف القتل والاغتيال للناشطين في العراق، ووقفاً لإطلاق النار باليمن. هي مطالب وجودية لحوالي مائة مليون عربي، يواجهها زعيم الحزب بلبنان و”أبو فدك” بالعراق، والحوثي باليمن والفاطميون والأسد الضرغام في سورية: مائة مليون يريدون حقّهم في الحياة والكرامة، وقد قُتل منهم إلى اليوم الملايين، وتهجَّر عشرات الملايين في بقاع العالم الأربع، ويواجههم الحرس الثوري الإيراني، تارةً بالافتخار بالاستيلاء على العواصم العربية الأربع، وطوراً بأنّ هذه هي طريقتهم في مواجهة الإمبريالية الأميركية، وإن لم يصدّق المصابون والجائعون القدرات الأسطوريّة للخامنئيّة فانظروا إلى لبنان حيث قال نصرالله إنّه يريد “كسر الدولار”، وفي الوقت نفسه هو الفريق الوحيد في لبنان الذي يتعامل مع محازبيه بالدولار. وهكذا هو وحده، وإلى جانبه باسيل بالطبع، القادر على تجاهل مصالح اللبنانيين وعقولهم.
إذا كان الأمر كذلك بالنسبة إلى سائر اللبنانيين، وإلى سُنّة لبنان على وجه الخصوص، الآن (سيطرة حزب الله وولاة أمره وحلفائه في لبنان وبعض المنطقة العربية) ومن قبل ومن بعد، فلماذا هذا الدوران من حول هذه الواقعة الفاقعة والهائلة والتردّد في المصير إلى مناقشة “عين المسألة”، كما قال السيّد المسيح لمارتا: “مارتا مارتا، تسألين عن أشياء كثيرة والمطلوب واحد”.
نعم علّة هذا الدوران تبيان السياقات التي حدث فيها تردّي الوضع الوطني والعربي، بما يُعين على فهم التحدّيات وكيفيّات مواجهتها. فمنذ استشهاد الرئيس رفيق الحريري، بل ربّما منذ استشهاد رياض الصلح في الخمسينيات، وإلى رشيد كرامي في الثمانينيات، كان موقف السنّة وموقعهم في الوطن والنظام ميزاناً لاستقرار لبنان واستمراره وازدهاره. وعندما يحدث اختلالٌ كبيرٌ بالبلاد كالحاصل الآن، فإنّ ذلك يكون شاهداً على تهميش الموقع والدور، وليس لأنّ رئيس الحكومة (رئيس السلطة التنفيذية) منهم فقط، بل ولأنّهم اللُّحمة السياسية والاجتماعية، والراديكاليّتان المسيحية والشيعية هما اللتان تتمرّدان، منذ السبعينيات من القرن الماضي، مطالبةً بحقوق مهضومة أو سيطرة مرغوبة. ويحاول السنّة دائماً (وإن بالتظاهر بالإعراض والحَرَد) إرضاء الطرفين أو الأطراف، بما لا يخلُّ بالاستقرار وبالعيش المشترك، وبعلاقات لبنان العربية والدولية.
بعد كلّ خطابٍ للحريري فيه شدٌّ للعصب بعض الشيء، تندفع النخب السنّيّة والجمهور من وراء سعد. وبعد كلّ انتكاسة، يندفعون أكثر حنوّاً عليه وحفظاً له. ما أخذنا العبرة ولا راجعنا الدروس، ولا شخَّصْنا الوضع الذي نحن فيه
لقد ضاع الموقف والموقع والدور بالتدريج منذ استشهاد الرئيس الحريري عام 2005، واحتلال بيروت عام 2008. هو اختلالٌ في موازين القوى الإقليمية والمحلّية انعكس مباشرةً على السنّة (قتل الحريري واحتلال بيروت)، وعلى حلفائهم في 14 آذار، وصولاً إلى انكسار حراكات الصمود بإسقاط حكومة سعد الحريري الأولى عام 2011. وخلال الأعوام من 2011 إلى 2014، صارت السنّيّة السياسيّة وحيدةً. بعد أن غادر جنبلاط عام 2009 إلى مظلّة الحزب، ومضى جعجع إلى مظلّة عون، وظهرت راديكاليّات انتحارية في أوساط الجمهور، وعادت الاغتيالات، وعمَّ القتل العشوائي على السنّة فيما بين سورية ولبنان والعراق.
لقد وصفتُ هذه العملية المضنية والاستنزافية مراراً في “أساس”. وقلتُ إنّ تلك الأحداث المتوالية والمتتالية، التي لا يجوز تجاهُلُ سياقاتها الإقليمية والدولية المستمرّة حتّى الآن، كانت من جهةٍ أُخرى تطرح أسئلةً وتتطلّب إجاباتٍ على السُنّة ومن السُنّة وسائر اللبنانيين. بدا السواد الأعظم من الشيعة في لبنان أنّه حسم أمره لجهة الولاء للجمهورية الإسلامية، ولجهة إرادة السيطرة بالسلاح على الداخل. وبدت كثرة معتبرة من المسيحيين مع الجنرال عون ليس في وصوله إلى رئاسة الجمهورية فحسب، بل وفي أنّه محقٌّ في أنّ السنّة هم الذين أكلوا حقوق المسيحيين، بالدستور وبالواقع، وأن لا سبيل لاستعادة الحقوق إلاّ من خلال “تحالف الأقلّيّات”.
ماذا فعل السنّة، قيادةً وجمهوراً، إزاء هذا الواقع المقبض؟ عرفنا ردّة فعل الراديكاليّات الصغرى المصنوعة، وهي ليست من طبيعة السنّة واجتماعهم الديني والوطني والاجتماعي. وأمّا القيادة (وقد صارت في الغالب سعد الحريري وحده) فكانت تقابل كلّ تحدٍّ بالتنازل السياسي والوطني، وبلغت القاع الأول بالتسوية مع عون، والقاع الأعمق بالاستظلال الكامل بالثنائي الشيعي. وكانت المعاذير دائماً بالاختلال الاستراتيجي، وبتجنّب الفراغ في المؤسسات الدستورية، وتجنّب العنف القاتل الذي كان الحزب يمارسه ولا يزال.
وبعد كلّ خطابٍ للحريري فيه شدٌّ للعصب بعض الشيء، تندفع النخب السنّيّة والجمهور من وراء سعد. وبعد كلّ انتكاسة، يندفعون أكثر حنوّاً عليه وحفظاً له. ما أخذنا العبرة ولا راجعنا الدروس، ولا شخَّصْنا الوضع الذي نحن فيه. وفي كلّ الأحوال ما فكّر فريقٌ معتبرٌ منّا بالدعوة إلى تغيير القيادة سبيلاً إلى الفهم الأفضل والكفاءة الأعلى والتقدير الأَوْلى للتاريخ والموقف والدور والحاضر والمستقبل. لقد بلغ من تهافُت الموقف والموقع، وليس الدور فقط، أنّه في اجتماع المجلس الشرعيّ الأخير، الذي حضره سعد الحريري، ما كاد الدستور يُذكَر إلاّ في سياق الدفاع عن “صلاحيّات” رئيس الحكومة، ولا ذُكِرت المحكمة الدولية التي تكاد تنتهي، وخُصِّصت فقرة كاملة للتظلّم من ضياع بعض الوظائف بالإدارة (هذه المرّة في وزارة التربية) من حصّة أهل السنّة، وتجاهل الحاضرون الانقلاب الهائل الذي شارك فيه الحريري بإجراء التسوية مع عون عام 2016، وأقلّ ما ضاع بسببها ولمصلحة باسيل وحده مئات الوظائف من شتّى المراتب. بيد أنّ الأشدّ هولاً، بالطبع، تخريب إدارة الدولة والوظيفة العامّة، وسرقة المليارات وهدرها، وتسليم البلاد إلى ميليشيا الزعيم. وهذا الأمر لا يختلف فيه سعد الحريري عن عون وباسيل.
لا فائدة من الشكوى والاستمرار فيها. فالوقائع صارت مكرورة ومعروفة، وكذلك النتائج. ونحن صرنا طائفةً مثل أصغر الطوائف، بل ونحن اليوم (وعددنا مليون ونصف مليون) الأشدّ فقراً واحتياجاً من بينها. هل ننسب ذلك كلّه إلى سعد الحريري، الذي جدّدنا له أخيراً الإجماع على عدم الاعتذار بحجّة الصلاحيّات والأوحدية، التي ما وفى بشروطها منذ العام 2011، إن لم يكن منذ العام 2008؟!
لا أعتبر تحميل الحريري وحده المسؤولية، سنّيّاً أو وطنيّاً، ظلماً، بل قلّة عقل. لكنّ الصحيح أنّنا محتاجون بشدّة إلى “تصحيح المسار” الإسلامي الداخلي والوطني. فالمسؤوليات عن الانهيار الوطني مشتركة، وكذلك المسؤوليات عن “انحطاط الهمّة” لدى السنّة مشتركة. لكنّ مقادير المسؤوليات تتفاوت بالتأكيد بين طرفٍ وآخر. وأنا أعرف أنّه في عدّة قراراتٍ مصيرية على المستوييْن السنّي والوطنيّ العامّ، انفرد سعد الحريري باتّخاذ القرار على الرغم من معرفته وإقراره بوبال المآلات التي أقدم عليها. بعد التسوية عام 2016، كان الحريري في فكره وقراره ثلاثة أثلاث للحزب وباسيل وبني قومه. أمّا اليوم فما عاد عنده غير الثنائي الشيعي. وإذا كان الهدف مشروعاً (تشكيل حكومة)، فينبغي أن يكون قد صار واضحاً لديه أنّ الحزب المؤيِّد علناً، هو الذي لا يريد تشكيل حكومة، وإلا فانظر كيف يريد حلَّ مشكلة المحروقات، والمشكلة الاقتصادية، حتى النزاع بين الحريري وباسيل (ويا بخت من جمع راسين في الحلال!).
لقد دأبنا منذ العام 2005، وفي كل مناسبة، على تجديد البيعة لسعد الحريري، وفي لحظات الفشل بالذات. وهجومه، هذه المرّة، على الترشّح لتشكيل الحكومة، هو فخٌّ أُوقِع فيه، كما قال له النائب نهاد المشنوق
إستمعت يوم الأحد (أي أمس) إلى خطبتيْ البطريرك الراعي ومطران بيروت الأرثوذكسي في إدانة مسبِّبي الانهيار، والطبقة السياسية الفاسدة، والمطالبة بتشكيل حكومة لإدارة البلاد، فخجلتُ من التخاذُل السنّي والتصاغُر، وخجلتُ أيضاً للأحزاب المسيحية الأُخرى التي لا تفكّر بغير الانتخابات، وبهذا القانون الأعوج.
لقد دأبنا منذ العام 2005، وفي كل مناسبة، على تجديد البيعة لسعد الحريري، وفي لحظات الفشل بالذات. وهجومه، هذه المرّة، على الترشّح لتشكيل الحكومة، هو فخٌّ أُوقِع فيه، كما قال له النائب نهاد المشنوق. إنّما في كلّ الأحوال، الحريري في قلب فشلٍ جديدٍ سببه الدوران في هذه الحلقة المفرغة التي حُدِّدت له. وهو الذي قَبِل شروطها كما في كل مرّة. ولذلك إذا لم نُرِد الإصرار العاجز أو الإجماع السلبيّ يكُن علينا الخروج من هذه الحالة المخزية بالتنادي لأحد أمرين:
– الإجماع (ونحن السنّة نحبّ ذلك لأنّنا أهل مدينةٍ وجماعة): إنّما هذه المرّة على مطالبة سعد بالاعتذار، والذهاب إلى خياراتٍ سياسيةٍ أُخرى خارجية وداخلية نعمل عليها بشكلٍ جماعيّ، ولا نظلّ مرتهنين للصراع مع باسيل، أو الخضوع للثنائي الشيعي. نصر الله تحدّانا: إن لم نُرِد البترول الإيراني المزعوم، فلنذهب إلى الخليج. وبالطبع، هو وعون هما اللذان قطعا علاقات لبنان بالخليج. إنّما بالفعل: لماذا خضعنا لذلك، ومن منّا يملك حتى الآن علاقاتٍ معتبرة بالخليج العربي؟! وبالداخل: سعد الحريري اختار (ويا له من اختيار!) أن يوافق على قانون الانتخابات الذي قسّم الوطن طائفياً، وخسّره 15 نائباً(!)، فلماذا يكون علينا تكرار التجربة الخطيئة، ولماذا لا نسير باتجاه خياراتٍ أُخرى، ولو عارضتها الأحزاب المسيحية؟ هناك قانون الانتخابات، وهناك مشروع يعمل عليه الرئيس نبيه برّي. لماذا لا يكون عندنا مشروعنا، ومشروعاتنا في العادة لا تُلغي أحداً، ولا تقلِّلُ من شأنه. لقد ضربتُ هذين المثلين للخيارات الجديدة الممكنة عربياً ووطنياً، وهي خيارات سدُّوها علينا، وخضع لها سعد الحريري، وهناك دعوة له للمرّة الأخيرة للسير في طريق وطريقة الفعالية الإسلامية والوطنية.
– المعارضة والعمل على البدائل. فإن تعذّر الإجماع على الاعتذار من أجل التحرّر من الأسر والاستنزاف، فليمضِ الذين لا يريدون منّا أن يبقوا أسرى أو لامبالين باتجاه المعارضة بالداخليْن الإسلامي والوطني. وعلى كلّ حال، قد دخل معظمنا هذه الحالة من أجل استيعاب الشباب من جهة، والبحث عن بدائل للقيادات السنّية الموجودة، التي أتعبها الخضوع وعدم الفعّالية أكثر ممّا أتعبها العمل. نحن أحرارٌ تماماً، ونحن الأحقّ (ممّن لم يشاركوا في التسوية المرذولة) بالالتزام بالثوابت الوطنية والقومية، والالتفات إلى ما أصاب الوطن والمواطنين. نحن الفئة الأولى وطنياً المهدَّدة بأن ينفلت شارعها إلى الفوضى التخريبية نتيجة استنزافات العقد ونصف العقد، واختراقات الأجهزة وهوامات الغوغاء.
إمّا الإجماع على تغيير المسار، أو معارضة السائد إسلاميّاً ووطنيّاً من أجل التغيير.